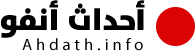AHDATH.INFO- يونس دافقير
بين تأجيل الانتخابات أو تنظيمها في موعدها، توافقت الدولة والأحزاب على الالتزام بالآجال الدستورية. في ذلك انتصار للمقاربة الديمقراطية على خطاب الأزمة واستثنائية التدبير، هذا هو الجانب المشرق في المسألة، أما جانبها الآخر فتبدو فيه الدولة والفاعلون السياسيون كما لو أنهم يغامرون بتنظيم الانتخابات في زمن غير مناسب.
شبح 2007 يحلق في سماء 2021
قبل أسابيع قليلة كان محمد أوجار، العضو القيادي في التجمع الوطني للأحرار، قد طرح من جديد فكرة التصويت الإجباري، وبغض النظر عن الفكرة ومآلاتها، تكشف خلفياتها عن أن السياسيين لديهم تخوف جدي من أن يملأ عزوف الناخبين صناديق الاقتراع في انتخابات 2021.
في الشرعية الانتخابية قد ينهزم هذا الحزب أو ذاك، وقد تتغير ملامح الخارطة الانتخابية… كل ذلك وارد في اللعبة السياسية، لكن أمرا ظل دائما مثيرا للقلق: نسبة المشاركة الانتخابية التي تحدد مدى توفر اللعبة السياسية والخيار الديمقراطي على قاعدة اجتماعية تدعمهما.
ومن دون شك، يؤدي انخفاض نسب المشاركة إلى التقليل من الشرعية الانتخابية للمؤسسات المنبثقة عنها، ويخلق تفاوتا بين مؤسسات الشرعية الانتخابية وباقي المؤسسات، هذا جانب، والجانب الآخر أن مقاطعي العملية السياسية يعتبرون وباستمرار ذلك نصرهم الموضوعي. هي إشكالية قديمة، لكنها تعود إلى الواجهة باستمرار، وبقلق أكبر من سابقه.
في 2007 عشنا ذلك السقوط المدوي للشرعيات الانتخابية، نسبة المشاركة في اقتراع شتنبر لم تتجاوز 37 في المائة، كان ذلك مدعاة للخوف، وبدا أن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة حينها، كان محاولة من بين مساعي أخرى، لاستعادة الانتخابات لقواعدها الاجتماعية، لتبقى على الأقل في الحدود التي سجلتها انتخابات 2002 بنسبة 51.6 %،
ماذا حدث بين 2002 و2007 حتى يتراجع منسوب الشرعية الشعبية للانتخابات؟ قد نحصي في ذلك مآل حكومة التناوب، وقد نضيف إليه أن شرعية الإنجازات الملكية في تلك الفترة (الإنصاف والمصالحة، مدونة الأسرة…) حجبت الأضواء عن الأحزاب، وهناك مسألة أخرى أوضحها بتفصيل المستشاران الملكيان في آخر حوار صحفي لهما: تم الانتقال من الإفراط في السياسة إلى ما هو انشغال أكبر بما هو اقتصادي.
وكان واضحا أيضا أن المحركات الحزبية الرئيسية للحياة السياسية والعملية الانتخابية قد انهارت، الاتحاد الاشتراكي أنهكته تجربة حكومية دخلها حزبا واحدا وخرج منها بثلاثة أحزاب ونقابتين، حزب الاستقلال بدوره فقد آلته الانتخابية الكلاسيكية رغم احتلاله الرتبة الأولي في 2007، اليسار المؤسساتي زادت عزلته.. وأمام هذا النزيف الانتخابي فرغت الساحة للإسلاميين: القوة الصاعدة آنذاك.

خريف انتخابي في «ربيع عربي»
سنة 2011 ساد اعتقاد بأن «الربيع العربي» سيعيد للشرعية الإنتخابية هيبتها، كل المؤشرات بل المعطيات تشجع على ذلك: دستور جديد يربط المسؤولية بصناديق الاقتراع، الحكومة شريك في السلطة، الأحزاب انتقلت من وظيفة تأطير المواطنين إلى ممارسة السلطة التنفيذية، توسيع الحقل المدني على حساب الحقل المقدس من خلال إعادة هيكلة الفصل 19 الذي كان مرجعية في سمو الشرعية الدينية على باقي المشروعيات، تحرير جديد للعبة السياسية، حماس في الشارع نحو التغيير…
ومن الواضح أن هذه الأجواء لم تترجم إلى نسب مئوية استثنائية في نسب المشاركة، مثل هذه المحطات التي تعرف كثافة سياسية من المفترض أن ترفع شهية الإقبال على صناديق الاقتراع، لكن النسبة لم تتقدم كثيرا ولم تسجل سوى 45 ٪، قد يظهر أن المشاركة ربحث ثماني نقط مقارنة بـ2007 لكنها خسرت ست نقط مقارنة بـ2002، لذلك من الواضح أن الأحزاب التي فازت بتلك الانتخابات لم تستقطب إلا نسبا ضئيلة من الناخبين الجدد إلى اللعبة الانتخابية بينما اجتذبت أغلب أصواتها من نفس الوعاء الانتخابي القديم.
العدالة والتنمية استقطبت أصوات الطبقة المتوسطة التي كانت تصوت لليسار، والأصالة والمعاصرة التهم أصوات الحركة الشعبية والتجمع وغيرهما من الأحزاب الصغرى، اليسار الذي قادته حركة عشرين فبراير في الشارع بدل أن يقودها ترك ناخبيه على هامش اللعبة قبل أن يعود إليها بشكل كاريكاتيري سنة 2016:
ومع ذلك ثمة مفارقة: رغم أن نسبة المشاركة كانت محدودة أو متوسطة سنة 2011، إلا أن الفرجة على المشهد السياسي الذي تمخض عنها كانت مرتفعة، الممثلون الجدد فوق خشبة المسرح السياسي اجتذبوا جمهورا جديدا، كانت المواجهات بين الرباعي حميد شباط وإلياس العماري وإدريس لشكر وعبد الإله بن كيران عرضا مسرحيا مغريا بالمتابعة، لكن الجمهور في الغالب كان يتسلل إلى المسرح دون أن يحجز ورقة الدخول، ولذلك كان جمهورا غير محسوب في العائدات الجماهيرية للعبة السياسية.
يقول أرسطو إن كل نظام يحمل في أحشائه عناصر فنائه، وقد كانت هذه الفرجة المبالغ فيها هي سبب انهيار خشبة العرض السياسي المسلي، أو لنقل إنه تحول من ملهاة إلى مأساة: الاحتقان السياسي الذي تولد عن الصراع بين الزعامات الصدامية، تقلبات اللعبة البرلمانية بين توالي الأزمات ومنها انسحاب الاستقلال من الحكومة وتعويضه بالتجمع… كل ذلك سيقدم عرضا سيحكم عليه الناخبون في انتخابات 2016.
ومرة أخرى تعود الأرقام إلي الوراء، الناخبون أو الجمهور سيعطي حكمه على العرض السياسي الذي قدم أمامه فوق خشبة المسرح الحكومي والحزبي، في النتيجة 42.29% فقط انتقلوا إلى مراكز التصويت، كان صادما أن تنتهي كل العملية السياسية الباذخة على مدى خمس سنوات إلى فرار جماعي من اللعبة وفقدان قرابة ثلاث نقط في خمس سنوات.
ليس ذلك بحالة مغربية خالصة، لتأخذ على سبيل المثال التجربة التي تقدم على أنها الأكثر ديمقراطية في محيطنا المغاربي، في تونس عاش التونسيون بذخا ديمقراطيا من داخل نظام برلماني تعددي حزبي، انتخابات قليلة وعدد كبير من الحكومات، التونسيون الذين تحمسوا لتجربتهم السياسية البرلمانية سينقلبون عليها لاحقا، ما كشفته أرقام الانتخابات الرئاسية الأخيرة يشير إلى أنه بينما تراجعت المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بنسبة عشرين نقطة لتبقى في حدود 40 في المائة بعدما كانت 60 في المائة سنة 2014 نلاحظ أن هذه النسبة صارت في ارتفاع لتصل إلى 55 في المائة في الاقتراع الرئاسي.
يعبر ذلك عن آمال جيل جديد من التونسيين عكسته نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و28 عاما صوتوا لصالح قيس سعيد. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن سعيد حاز تقريبا على ثلاثة ملايين صوت، وهو ضعف عدد الناخبين الذين صوتوا لانتخاب 217 نائبا في الانتخابات التشريعية فقد نقرأ في ذلك تقوية لشرعية الرئيس رغم محدودية صلاحياته مقابل شرعية البرلمان والحكومة التي ستنبثق عنه.
إن السؤال الذي يطرح هنا هو ما إن كان الناخب التونسي قد بعث رسالة سياسية ودستورية تفيد أنه لم يعد واثقا في الطابع البرلماني للنظام السياسي التونسي، وأنه ربما يرغب في الانتقال إلى نظام رئاسي بعد الترهل الذي أبانت عنه اللعبة السياسية بفعل الصراعات الحزبية داخل البرلمان.

أزمة الثقة تعودة بقوة
تزامن تراجع معدل المشاركة الانتخابية سنتي 2015 و2016 مع ظهور متغيرات مقلقة، التعبيرات الاجتماعية الجديدة عمقت أزمة الثقة في الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، أحداث الحسيمة وجرادة وغيرها أظهرت أن هوة سحيقة تفصل بين المواطنين والسياسيين، ونظرا لإحباطات السياسات العمومية، زاد الخطاب الشعبوي والعدمي الصورة قتامة، لقد كانت هذه الإحباطات بمثابة البيئة الحاضنة لكل تفكير مناهض للانتخابات ولكل ما هو حزبي، بل إن الدولة نفسها لم تسلم من اهتزازات الثقة.
في تلك الأشهر السوداء سمعنا الكثير من أزمة مؤسسات الوساطة، خطاب ظل ومايزال سائدا في الساحة يتقاسمه الرسميون وغير الرسميين، وفي خطاب العرش ليوليوز 2017 سيأتي خطاب الملك ليظهر أن هناك أمة ثقة مزدوجة: ناخبون لا يثقون في السياسيين، وملك فقد ثقته في جزء من طبقته السياسية.
في ذلك الخطاب سيقول الملك بالحرف:
«لقد أبانت الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.
إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.
أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.
ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين.
فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيء للعمل السياسي.
إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين، لمنطق الربح والخسارة، للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع.
إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى، قد زاد من تأزيم الأوضاع.
لكن السياسيين يحاولون ما أمكن تناسي هذا الخطاب، واعتباره كأنه لم يكن، وكأن الملك كان يتوقع منهم ذلك، ولذلك قال في نفس الخطاب: «ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم».
وكل ما حدث بعد ذلك هو أن الملك محمد السادس مارس مهامه الدستورية في كل الخطب التي تلت خطاب العرش هذا. وفي كل تلك الخطب كنا أمام ما أسميته سابقا «الإنقاذ الاجتماعي للسياسة». استوعبت الدولة الدرس لاحقا. وقد كان واضحا من خطابي الملك محمد السادس في عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب أن المسار السياسي سيكون ذا حمولة اجتماعية، وليس مهرجانا جديدا في حقل الأحزاب.
ومنذ ذلك الوقت بصم الملك على حضور قوي في الإشراف الشخصي على التوجه الاجتماعي الجديد للسياسات العمومية، وفي حفلين متتاليين ترأس تقديم حصيلة البرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس، وتقديم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم انتقل إلى التكوين المهني، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والقطاع الصحي، ودعم مشاريع الشباب… في كل هذه السياسيات الكبرى نزل الملك بكل ثقله لإنقاذ الدولة من فشل السياسيين ومن غضب الناخبين.

كورونا.. السياسي يعمق أزمته
في تلك الفترة بدا الرهان كبيرا على هذه الخطوات من أجل استعادة الثقة في السياسة وفي المؤسسات، غير أن تحولا آخر لم يكن في الحسبان سيربك كل الحسابات، وباء كورونا بعثر أوراق العالم، وفي المغرب أدت الطوارئ الصحية والحجر الصحي إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة، وضغط اجتماعي يمكن وصفه بالرهيب. لقد أدت هذه الظرفية إلى تعليق كل المشاريع الاجتماعية لإنقاذ السياسة وتسببت في إضعاف السياسيين.
ومرة أخرى سيكون على الدولة أن تتجاوز السياسيين وتنزل بكل ثقلها، بدت دولة الرعاية الاجتماعية التي تم استدعاؤها من كلاسيكيات الديمقراطيات الاجتماعية الوصفة السحرية، لكنها مكلفة ماليا، تكلفت الدولة برعاية الفئات الهشة، وصرفت تعويضات مالية لمن فقدوا عملهم أو توقفوا عنه، النظام البنكي تعرض لضغط كبير، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحمل أعباء إضافية، ولأن ميزانية الدولة عاجزة عن تحمل هذه التكاليف، تم اللجوء إلى التبرعات الإنسانية للأفراد والمؤسسات… إجمالا تحولت الدولة إلى «أم ترعى أبناءها»، وسعى كل طرف إلى أن ينسى أو يتناسى خلافاته مع الطرف الآخر.
كانت لحظة غير مسبوقة في استعادة الثقة في الدولة، ومرة أخرى كانت لحظة قاسية وضعت الفاعل السياسي والمنتخبين على هامش العملية برمتها، وحتى الخرجات المحدودة لرئيس الحكومة التي كان من شأنها طمأنة الناس بأن منتخبيهم يشرفون على أمورهم ظلت تعطي نتائج عكسية، وترسخت في أذهان الناس فكرة أن حكومة تقنقراطية مصغرة هي من يقود البلد، وظهرت مع ذلك فكرة أن الأزمة التي نحن بصددها هي أزمة استثنائية تستدعي جوابا استثنائيا عبر عنه البعض بحكومة تقنقراطية، والبعض الآخر بحكومة إنقاذ أو وحدة وطنية…
والأسبوع الماضي حسمت الدولة أمرها بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في موعدها، احتفل السياسيون بنصرهم على التقنقراطية ومقارباتها وتحرشاتها، لكنه نصر غير مكتمل، لأن كل المسار الذي سردناه يبين أن أزمة الثقة ماتزال قائمة، وأن النزيف فيها مستمر، وشبح العزوف الانتخابي وارد بقوة في 2021، ما لم يتم اتخاذ تدابير خاصة لإقناع الناخبين بأنهم سيكونون إزاء انتخابات خاصة جدا.
إجراءات الإنقاذ الانتخابي
- 1- استثمار رأسمال الثقة في الدولة خلال جائحة كورونا، وتقويته من خلال تجويد سلوك السلطة في العلاقة مع المواطنين والبحث عن صيغ لاستمرار الدعم العمومي للفئات الهشة التي ستبقى ضحية التبعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19.
- 2- العودة إلى نمط الاقتراع الفردي بعد أن ظهرت محدودية قدرة الاقتراع اللائحي في تحقيق أهدافه المتعلقة بعقلنة المشهد الحزبي، والانتقال من التصويت الشخصي إلى التصويت السياسي. فعلى الأقل الاقتراع الفردي يضمن احتذاب ناخبين جدد.
- 3- إجراءات تعزيز جاذبية المؤسسات المنتخبة من خلال إلغاء الامتيازات البرلمانية كتصفية صندوق معاشات البرلمانيين، وإلغاء امتيازاتهم غير الضرورية للعمل البرلماني.
- 4- إخضاع نفقات الدولة لريجيم قاسي في قانون مالية 2021 يتم معه إلغاء الامتيازات المالية الممنوحة لكبار الأطر أو تخفيضها على الأقل.
- 5- تطبيق أقصى التدابير الزجرية في حق المخالفين للقانون، سواء في حالات الفساد أو عدم التصريح بالممتلكات أو الاغتناء غير المشروع.
- 6- تغيير جذري في أسلوب الحملة الانتخابية والبرامج التلفزيونية والإذاعية المواكبة لها في الاتجاه الذي يحقق لها الجاذبية والتتتبع.
- 7- استبعاد المشبوهين والأميين من الترشيح، واعتماد قوائم ترشيحات تضم بروفايلات وكفاءات قادرة على جلب ثقة الناخبي
- 8- الصرامة في معاقبة المتلاعبين بحرية الاقتراع ونزاهته، وحرص الأحزاب على تفادي خطاب التشكيك في العملية الانخابية.
- 9- اعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية وتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى السبت أو الأحد.
- 10- برامج انتخابية واقعية تتميز بالقرب من قضايا الناس، وقابلة للتطبيق خلال الولاية الحكومية.