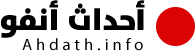AHDATH.INFO - حاورته حليمة عامر
يرى خالد لحسيكة، أنه رغم التحولات التي مست المجتمع المغربي حوالي نصف قرن من التحول التحديثي العملي والسطحي، إلا أنها لم تكن مصحوبة بتحولات ثقافية وقيمية موازية ومناسبة لهذا المعاش الحديث، مثل تمثلالمجتمع لقضية المساواة بين الذكور والإناث وتطور بنيات العلاقات الأسرية، نظرا لطبيعة الدولة ونسقها السياسي والمعياري، الذي لم "يسمح بتحديث ثقافي، قد يربك شرعيتها التقليدية نظرا لطبيعة الإرث الكولونيالي والماضوي الذي تستند عليه لبناء نموذج بناءها الثقافي والاجتماعي".
وقال لحسيكة، إن الحداثة الثقافية للمجتمع المغربي "معاقة"، نتيجة مباشرة للنموذج التنموي الذي أسسه "ليوطي" والذي حافظ على هذه البنيات التقليدية، حيث عمل هذا الأخير على بناءها في المخيال الجمعي، حتى حينما لم تكن مواصفاتها تتيح هذا البناء التقليدي الذي يستند على ماضوية متخيلة في أغلب الحالات، وبعيدة حتى على الموروث الثقافي الذي صاغتها نظم العيش المغربي.
وفي هذا الصدد، التقى موقع "أحداث أنفو" خالد لحسيكة، أستاذ باحث في علم الاجتماع الأسرة والنوع الاجتماعي بالمعهد الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس بالرباط، فضلا عن مساهمته المستمرة في النقاشات العلمية بأبحاثه التي أنجزها حول سياقات تحول البنيات والعلاقات الاسرية في المجتمع المغربي، وحول قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي،وحول المقاومات الثقافية لخطاب حقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي والعدالة الانتقالية، هذا بالاضافة إلى اشغاله على موضوعات الإعاقة وتمثلات الجسد المختلف، وكان هذا الحوار في جزئه الأول.
رغم المسار الذي قطعه المغرب على مستوى حقوق المرأة، ورغم دينامية التحول الثقافي والاجتماعي التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقود الأخيرة.لماذا ظلت بنية العلاقات الاجتماعية في المجتمع المغربي تنطوي على سلطة الذكور على النساء، ونسب ظواهر العنف ضد النساء مرتفعة؟
أود قبل الجواب افتحاص دقة السؤال أولا.هل صحيح أننا أمام تنامي واقعي لظاهرة العنف داخل المجتمع المغربي، وهل فكرة تزايد منسوب ممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي تستند على تحليل إحصائي مقارن؟ أم هي إنذار بتحول في تصور المجتمع لهذا العنف؟. ليس لدينا أي دليل علمي يؤكد هذا الارتفاع وليس لدينا كذلك دليل ينفيه. فقد يكون هذا الإحساس ناتج حالة الانكشاف المتصاعد لظواهر ظلت محجوبة ومحاطة بجدار الحميمية الخصوصية والستر والخوف من الوصم والافتضاح. وقد تكون هاته الفكرة عاكسة لواقع مقاومة الثقافة الذكورية للتحولات الجارية في كينونة النساء في المجتمعالتي تتمظهر في ميول أكبر لدى النساء للاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية, للمشاركة الاجتماعية واحتلال متنامي للفضاءات العمومية،و كذا تفاعلية أسرية من نوع جديد يسودها القرار المشترك والتدبير المنزلي المزدوج، ومساءلة متزايدة لشرعية الهيمنة الذكورية في كل نواحي الحياة الخاصة والعامة. كل هاته المسارات الجديدة لا يمكن ان تمر دون مقاومة عملية وقيمية من طرف من ليس لهم المصلحة في إعادة ترتيب الأدوار والمكانات الجنسية داخل الفضاء الحميمي وحتى داخل الفضاءات العمومية.
من كل هاته المسارات، أميل الى افتراض أنه هناك انخفاض في نسب تعرض النساء للعنف بكل أنواعه، ففي كل الظواهر الاجتماعية لا يمكن مقارنة الزمن الذي يكون فيه العنف نسقيا واعتياديا وشبه شرعيا،وبين زمن أصبح فيه هذا العنف غير مقبولا اجتماعيا ومعياريا. ينبغي اتخاد الحيطة والحظر لحظة المرور من واقع خضوع ظواهر مثل العنف المبني على النوع للحجب الى لحظة تحوله لظاهرة مرئية خاضعة للسجال الثقافي والاجتماعي،منكشفة وقابلة للإحصاء، وبالتالي مبنية اجتماعيا وسياسيا.
إن العنف خاصية ثقافية يحملها الإنسان معه كجزء من ذاكرة انتماءه للطبيعة،التي جعلت منه قاعدة وقانونا للسيادة والصراع من أجل البقاء. فمنذ ظهور الإنسان وانتظامه في مجتمعات وعشائر ذات بنيات أولية، لازمته هذه الخاصية، فكل المجتمعات البشرية بنيت على قواعد القوة التسلط والخضوع.
عبر التاريخ أدى ظهور الدولة الى انتقال وتحول جوهري في طبيعة العنف الاجتماعي وشرعية ممارسته. أصبح دورها ووظيفتها الأساسية هو احتكار وتنظيم العنف، وأصبح الجنود ورجال الدولة والمكلفين بالأمن العام للمدينة الوحيدين المخول لهم ممارسة عنف مؤسساتي باسم المجتمع وشرعياته. باستثناء موضوع العنف اتجاه المرأة، الذي بقي مشاعا في المجتمع، حيث حافظ الذكور على حقهم في ممارسته. وبقي عبر العصور يكرر نفس السؤال: لماذا تأسست المجتمعات البشرية منذ الأول على ضرورات الهيمنة الجنسية الذكورية ؟
تحقق هذه الهيمنة لم يكن ليتخذ طابعا بنيويا ضامنا لسيرورة إعادة إنتاج مستمرة، لولا تشكل الوسائط الأيديولوجية والرمزية من أديان وأساطير ومعتقدات سحرية، وكل المنظومات المعيارية التي تركزت وظيفتها في شرعنة العنف ضد النساء، وتأمين ميكانيزمات الهيمنة الجنسية.
إبعاد النساء خارج دائرة التعلم والمعرفة والسلطة، جعلهن مند البدايات الأولى لتشكل المجتمعات البشرية موضوعا للتبادل وأدوات لتحالف الذكور والجماعات .
ما يهمني في هذا المسار، هو أن العنف كان بنيويا تجاه المرأة، وكان دائما ينبغي إبعاد جسد المرأة عن السلطة والقوة وعن التعلم، لكي يبقى دائما في خدمة الذكور والمجتمع، ولكي يضمن السلطة للذكور.
هذه المواضيع ظلت تشكل طابوهات، لا يمكن الحديث فيها إلى أن جاءت الرأسمالية وبدأت المرأة تحصل على راتب، وبدأت تحتل الفضاء العمومي، حيث ستتمكن النساء من التمدرس وستتغير هذه المعادلة، ولن يبقى لظواهر الهيمنة الجنسية بجميع أشكالها نفس القبولالذي كان لها من قبل.
نتيجة لولوج المرأة للتمدرس، ستخترق النساء دوائر تملكالقوة والقدرة التي أسست عبر التاريخ معايير تفوق الذكور. ستتملك النساء حق الكلام وستلج مساحات الخطاب العمومي. ستستطيع المرأة كذلك الكتابة وستلجمسالك التنظيم الاجتماعي.
كان المجتمع الحديث كان مضطرا لتمكين النساء من التعلم، لأنه أصبح يحتاجهن في العمل والمقاولات والمصانع. ولأجل ذلك كان عليه أن يؤمن نوعا من التمدرس. ترافق هذا بظهور التوجهات الليبرالية التي ستحاول أن تعطي نظرة مغايرة للمجتمع والأفراد والمساواة بين الجنسين. بطبيعة الحال كان الهدف الأول وراء إخراج المرأة من البيت هو استغلالها في المصانع والمعامل، لكن هذا الاستغلال مكنها من أن تمتلك جزءا من عناصر القوة والاستقلال الاجتماعي. وبالتاليامتلاكها لمبررات وقدرة انتقاد السلطة التقليدية، التي تميزت بالسلطة المطلقة للذكور,
هذه الظواهر كانت ولا زالت ظواهر كونية، لم تكن تتميز فيها المجتمعات عن بعضها. وبالتالي فالحركة الرافضة لها ستكون كذلك كونية. بحيث ستظهر الأصوات الرافضة لأوضاع تهميش وإخضاع النساء منذ البدايات الأولى لدياناميات التصنيع والتحضر في المجتمعات الصناعية، لكنها ستتشكل في حركة نسائية وموجات ثقافية عند أواسط القرن العشرين.ومنذ ذلك الحين وهي تطور مكاسب حقوقية واجتماعية، تستهدف تغيير القيم والقوانين وكل أبعاد بنيات توزيع الأدوار والمكانات الاجتماعية في المجتمعات.
حركة التغيير هاته، عرفت تأخرا بنيويا في مسار تحول المجتمع المغربي. فبدايات التغير في وضعية النساء لم تبرز الا مع العقود المتأخرة لفترة الاستعمار، حيث ظهر تمدرس المرأة بوتيرة شديدة البطء. فمسار تمكين النساء من التمدرس والعمل خارج البيت، جوبه بنوع من المقاومة الثقافية والاجتماعية لا زالت بقاياها لم تندثر بعد، وإن اتخذت أشكال متنوعة في كل فترة. وهو أمر طبيعي في كل المجتمعات، فلا وجود لتنازل اختياري وطوعي عن السلطة والامتيازات والمكاسب . فكل من يمتلك السلطة والقوة، يتمثلها شرعية واعتيادية، وسيقاوم كل من يعمل على إعادة توزيعها أو تبخيسها، ويعتبره الشرعية المعيارية، وسيصنفه خطرا على توازن طبيعي موروث وقبلي ومتعالي. فقضية الهيمنة الجنسية هي قضية مصالح وامتيازات، قبل أن تكون مسألة ثقافة أو قيم.
الخطأ الفظيع الذي نقع فيه عند مناقشة قضايا النوع الاجتماعي والمساواة، هو أن نربطها على الدوام بالقيم، وبالمعاني. ولكن هي في الأصل مرتبطة بالمصالح.
لا يوجد أي ذكر سيتنازل طوعا عن امتيازاته ومكاسبه ، لأنه لديه امرأة في البيت تقوم بتجهيز الأكل وتربي الأولاد وتسهر على راحته، تأمن ممتلكاته وتنميها، وتوفر له حاجياته الجنسية والحميمية. فحين نأتي بين يوم وأخر ونقول له : ينبغي أن تساهم أنت كذلك في العمل داخل البيت، وعليك أن تقتسم القرار المنزلي، وأن تتنازل عن سلطتك على النساء في البيت والعمل والشارع العمومي. نقول هذا لذكور نشؤا داخل بنية أسرية غرست فيه قاعدة الهيمنة والتفوق الجنسي.
لكننا مطالبون بالتمييز بين الذكر والذكورية، فثقافة الهيمنة الذكورية هي جزء من البناء الاجتماعي لمواقع النوع وليس لها أية علاقة بالهويات البيولوجية. فما نعيشه من تحولات في بنية العلاقات الأسرية والجنسية، يتجه الى فصل الذكورة عن الذكورية. فكل البحوث والاستطلاعات السوسيولوجية الراهنة،تؤكد دينامية التغير المتنامي في تمثل الذكور لرجولتهم. فالجزء الأكبر لم يعد يعتبر العنف الممارس على المرأة عنوانا للرجولة. بل على العكس يكاد يجمع الذكور على اعتبار القوة والتسلط علامة على اضطراب عصابي في تمثل الرجولة، وليس عنوانا لرجولة حقيقية. أما الموقف من العنف الذكوري ضد النساء، فلقد أضحى فاقدا لكل اعتراف اجتماعي سلوكا ومرفوضا من كل فئات المجتمع. رغم أن المواقف المقاومة لسياق التحول في علاقات النوع الاجتماعي في المجتمع، لا زالت تميل الى تبرير هذا العنف وتحميل المرأة مسؤولية استثارته. نحن إذن أمام تحول جذري في بنية العلاقات الجنسية في المجتمع، تحدده مسارات التغير في نظم الانتظام الاسرية وأشكال التفاعلية المابين جنسية الجديدة، التي أنتجت أطرها الاجتماعية مسلسلات التحضر والتصنيع، وأفرزت مساحات تحققها سياقات تملك النساء للقدرة عبر ولوجهن للتمدرس والعمل خارج البيت. الذكور الذين يرفضون الأدوار التقليدية، هم ذكور مقتنعو بأن مصلحتهم لم ليست في علاقات العنف والهيمنة الجنسية، بل يعتبرون علاقات التكافئ والتفاعلية الاجابية شرطا لسعادتهم الشخصية.
إذن كيف يمكن تفسير صعوبة تطور وثيرة هذا المسار سوسيولوجيا؟
لقد عرف المجتمع المغربي حوالي نصف قرن من التحول التحديثي العملي والسطحي، حيث الطرق المعبدة والمقاولة والمدرسة وجاءتنا المدينة القوية والتحضر السريع، لكن هاته التحولات لم تكن مصحوبة بتحولات ثقافية وقيمية موازية ومناسبة لهذا المعاش الحديث.، فطبيعة الدولة ونسقها السياسي والمعياري لم يسمح بتحديث ثقافي قد يربك شرعيتها التقليديةنظرا لطبيعة الإرث الكولونيالي والماضوي الذي استندت عليه هذه الدولة لبناء نموذج بناءها الثقافي والاجتماعي. فحداثنا الثقافية المعاقة هي نتيجة مباشرة لاشتغالية النموذج الذي أسسه "اليوطي" والذي حافظ على هذه البنيات التقليدية، بل وعمل على بناءها في المخيال الجمعي حتى حينما لم تكن مواصفاتها تتيح هذا البناء التقليدي الذي يستند على ماضوية متخيلة في أغلب الحالات، وبعيدة حتى على الموروث الثقافي الذي صاغتها نظم العيش المغربي في المناطق الأمازيغية خصوصا .
إذن وجدنا أنفسنا أمام حداثة عاجزة عن إنتاج ثقافة عيشها المشترك المنسجم مع نظم عيشها الواقعية المرأسملة والعصرية.، وأمام أسرة إنتقلت من بنية عصبية كبيرة الحجم إلى أخرى مقلصة، ومعزولة نوعا ما عن قرابتها، ووجدنا أنفسنا أمام تحولات مضطربة متسارعة في وضعية المرأة، حيث ولجت المرأة التمدرس ووجدت نفسها أمام مسؤوليات جديدة. تأخر سيرورات التطور التحديثي الثقافي، كان وراء حالة الصدام الايديولوجي والسياسي وحالة التقاطب الشد التي عرفتها وتعرفها ساحة النقاش العمومي حول قضايا الاسرة والمساوات والجسد وعلاقات النوع الاجتماعي.
كان يجب أن ننتظر حتى نهاية التسعينات،كي تصبح هاته الموضوعات قابلة للتداول العمومي.
وهنا ستأتي الحركة النسائية من أجل قلب هذه المعادلة أليس كذلك؟
الحركة النسائية هي الأداة الاجتماعية التي استطاعت تحويل مشكلات ومطالب النوع الاجتماعي من مشكلات أيديولوجية ثقافية الى موضوعات للنقاش والمعالجة العمومية. أي انها الحركة الاجتماعية التي تمكنت من استكمال البناء السياسي لحقل المرأة والاسرة والجنس.
لا يكتسب أي فعل او ظاهرة اجتماعية وجودها الفعلي حتى يصبح متكررا وقابلا للتعيان والوصف والاقتسام العمومي. فحينما يكون لدينا مشكلة اجتماعية غير مرئية، اجتماعية، أي غير موصومة ومقتسمة، فهي مشكلة غير مبنية سياسية. فوجودها ضمن الشرعية الاعتيادية المقبولة لدى المجتمع، لا يجعلها توصف كمشكلة اجتماعية تحتاج للمعالجة. فموضوعة العنف ضد النساء كانت في حاجة الى تدخل الحركة النسائية لتخرجها من حقل الاعتيادي المقبول والشبه شرعي لدى المجتمع. فالعنف مثلا، كان ظاهرة نسقية منتشرة في المجتمع، فحينما كنا نشاهد شخصا يعنف زوجته في الشارع، كانلا يمكن أن نتدخل لإيقافه. يقال إنها زوجته، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها زوجته وبالتالي من حقه أن يعنفها. وأنه أمر خاص لا يجب للغير ان يتدخل فيه، فهو أمر وان كان غير لائق فهو امر عادي
مع ظهور السوسيولوجيا النسائية وتطور البحوث الميدانية حول قضايا المساواة والنوع الاجتماعي، ومع تحول موضوعات العنف الى موضوعات للملاحظة الإحصائية من طرف الأجهزة العمومية مثل مندوبية الإحصاء وبعض القطاعات العمومية، سوف يخضع موضوع المرأة المساواة والعنف المبني على النوع الاجتماعي للملاحظة والتحليل العلمي المكثفين. ما سيفرز خطاب إحصائي مؤسساتي وبحثي علمي حول ظواهر جديدة مثل موضوع الحياة الأسرية والأدوار المنزلية وتقسيم الأدوار بين النساء والذكور داخل المجتمع. الاشتغالية العلمية لسنوات الثمانينيات والتسعينيات شكلت أساسا لمرحلة البناء المعرفي حول قضايا النوع الاجتماعي المساواة والعنف ضد النساء في المجتمع. لكن هذا البناء المعرفي كان في حاجة الى الحملات الترافعيةوالديناميات التحسيسية التي قامت بها الجمعيات النسائية بالاشتغال على محورين أساسين العنفضد النساء ومشاركة النساء في القرار العمومي السياسي.، هكذا اشتغلت الحركة النسائية على العنف وأسست مراكز الاستماع للعنف داخل في كل الجهات والمدن.، وبدأت تقوم بحملات تشجع النساء على التبليغ عن العنف. وبدأت تقدم تقاريرا سنوية حول الشكايات التي تتلقاها من النساء، ومن خلال تلك الشكايات والشهادات أصبحت صورة المرأة المعنفة وبروفايل الرجل المعنف ترتسم في المشهد والخطاب العمومي والتداولي. تصنيف أنواع العنف الممارس على النساء، وتشخيص العنف الجسدي، العنف الاقتصادي والعنف الجنسي... وهنا تحول موضوع العنف داخل المجتمع من موضوع غير مرئي اجتماعيا إلى موضوع قابل للملاحظة قابل للتعيان الإحصائي والتوصيف،، وبالتالي أصبح من الممكن أن يتحول لموضوع سياسي قابل للتداول في الساحة العمومية وقابل للمعالجة القانونية والحقوقية.
إذن فالحركة النسائية بهذا المعنى، هي أول حركة اجتماعية استطاعت أن تحول المشكلات الاجتماعية المرتبطة بحقل النوع الاجتماعي والمساواة، إلى مشكل سياسي ، يتفاوض حولها المجتمع. تبتدئ هاته الفترة في منتصف العقد الأول من القرن الجديد مع خروج قانون الأسرة الجديد، وأميل الى عنونتها بمسار التحول القيمي والمعياري لحقل المرأة والاسرة والعلاقات المابين جنسية، والذي أصبح فيه المجتمع هو من يمتلك حركة التغير الاجتماعي، ولم يعد ينتظر ذلك من الدولة، لأن الخمسين السنة التي مرت كان الفاعل العمومي والفاعل الحزبي هو من ينتج التحولات داخل المجتمع المغربي، وبعد سنة 1999 سيظهر لنا فاعلين جدد، سينتجون التحول الاجتماعي داخل المجتمع والثقافي.
واليوم، هل خضع موضوع العنف لنفس هذه المعايير؟
لا زلنا بعيدين الى حد ما من المجتمع الذي تخلو فيه مظاهر العنف والإخضاع. فالأنظمة الاجتماعية الثقافية المبررة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لا زالت تتمتع بمستوى عال من القدرة الاشتغالية. والأنظمة القانونية والمؤسساتية لا زالت عاجزة عن حماية الأفراد الأكثر هشاشة من أشكاله المتنوعة، وخصوصا منها النساءوالأطفال. يتميز المشهد السياسي المغربي فيتفاعله مع قضايا المساواة بمحافظة الدولة وذكورية الفاعل العمومي المنتج للقوانين والسياسات، الذيلا زال يحتسبنسبيا على جبهة مقاومة التغيير. فالعنف باعتباره آلية لإخضاع الأفراد لعلاقة القوة، والعنف ضد المرأة هو النوع الأكثر استفادة من التبريرات والشرعنة الضمنية. وأخطر ما فيه، كما يسمي ذلك بورديو، هو استبطان ضحية هذا العنف لشرعيته. فالهيمنة الجنسية ستفقد كل شرعيتها يوم تقتنع كل النساء بلا شرعيتها.فالنساء هن أيضا جزء من عملية صناعة إيديولوجية الهيمنة الذكورية والعنف، يساهمن عبر التنشأة الاجتماعية في تكوين الذكور العنيفين والمقتنعين بتفوقهم الجنسي. فالأم التي ترغب في تأبيد سلطتها على أسر أبناءها بسبب افتقادها لاي مصدر حماية اجتماعية، تنتج استراتيجيات ابتزاز عاطفي مع أبناءها وتعتبر استقلال اسر ابناءها وزوجاتهم تهديدا لاستقرارها ومصدر عيشها وسلطتها. وهي بالتالي تعتمد الثقافة الذكورية وميكانيزمات الهيمنة الجنسية كوسيلة للاحتماء من افتقاد مصادر العيش والنفود ورضى ابناءها.
لكن الأوضاع الاجتماعية والقيمية آخذة في التغير، فالنساء لم يعدن بنفس القدر من الامتثال، والأسرة لم تعد تتيح نفس التفاعلية المابين جنسية، والمجتمع أصبح أقل تسامحا مع مظاهر العنف الجنسي والتسلط.
إذن، العنف هو ألية للإخضاع وتحقيق الهيمنة الجنسية فقط؟
لا يوجد للعنف وظيفة أخرى غير تأمين الهيمنة والخضوع. لا يوجد عنف من أجل العنف، اللهم في الحالات المرضية. لكن هل يمكن ان نعتبر المعنف شخص مريض، قد يجوز ذلك في حدود أن إنتاج فعل عنف مقصود وممنهج لا يمكن ان ينتج إلا عن شخصية عصابية فشلت في إخضاع غيرها، فتلجأ للعنف والإكراه لتأمين خضوع وامتثال الغير. فالذكر العاجز عن الحوار والتفاعل الايجابي، ينتج العنف لإخفاء مركبات نقص وإحساس مزمن بالعجز اتجاه القوة المتنامية للمرأة. لكن هذا التفسير لا يجب ان يجعلنا نعتبر مرضية المعنف تبرير وسحب للمسؤولية اتجاه الضحية واتجاه المجتمع. فليست المرأة المعنفة وحدها من تعاني من تبعات العنف الذكوري. فكل المحيطين بفضاء العنف من أطفال وجوار هم ضحايا الممارسات العنيفة. والخطير في الأمر، أن الرجل يمكن أن يتعرض للعنف في إطار علاقات قوة أخرى. من قبل مشغله أو من طرف إدارة عمله أو من طرف رجال الأمن في الشارع. ولكنه في بيته يتحول الى منتج للهيمنة والعنف.،ويمكن أنيصادف امرأة في الشارع، يعطي لنفسه الحق بأن يتحرش بها.
إذا تتبعنا مظاهر العنف التي تعيشها المرأة داخل المجتمع حاليا، سنجد أن العنف الزوجي والحميمي يعد أكثر أشكال العنف انتشارا. وقد نفسره بما تعرفه الوحدات الأسرية الحديثة من ميول تنازعي حول طرق إنتاج القرار الاسري،وتدبير الإنفاق والاستضافة وتربية الأطفال والعلاقات بالأسر الأصلية والحياة الجنسية، كلها موضوعات للتنازع، وبسبب غياب ثقافة الحوار والتفاعل الإيجابي وهيمنة الثقافة الذكورية على الأفراد والمحيط، تنزلق التنازعات الى حالات العنف تكون في غالب الأحيان ضحاياها الزوجات والأطفال.
أما العنف في الفضاء العمومي، الذي تتعرض اليه النساء بمختلف انتماءاتهن وطبيعة احتلالهن لهذا المجال، يرسم مشهد مقاومة ذكورية عنيفة واضحة، لهذا التواجد الجديد للجسد النسائي. تواجد أضحى تدريجيا عنوانا لجسدا منافسا على مساحات امتلاك القدرة والقوة.
ولوج المرأة لفضاءات التعلم والعمل، واحتلالها المتزايد لمكان ظل ظل ذكوريا لمدة قرون، أنتج في عقود قليلة تحولا جذريا في مورفولوجيا المجال العام. فالاختلاط لم يعد ظاهرة، بل وضعا اعتياديا، وتموقع النساء في مراكز إنتاج القرار العمومي لم يعد استثناءا. ، فالمرأة أضحت قاضية تنتج الأحكام، وشرطيةتضمن الأمن، ومتواجدة في معظم دوائر إنتاج القرار وتنظيم الحياة العمومية. وإن بشكل متفاوت لا زالت تنتصب أمامه أشكال متنوعة من المقاومة الثقافية والاجتماعية. كل هاته الاختراقات، شكلت تحديا لركن من اركان الثقافة التقليدية، لكن الواقع العملي يكسب هاته الاحتلالات بسرعة ما تحتاجه من اعتراف اجتماعي واعتيادية ثقافية ومعيارية.
إذن، تقصد بأن العنف الممارس على المرأة المغربية بجميع أشكاله من قبل المجتمع، يستمد شرعيته من الدين؟
ليست الأديان في حد داتها، من يخلق التمييز والعنف الجنسي،بل الاستعمالات الاجتماعية للأديان كوسيلة لإضفاء الشرعية على السيطرة الجنسية والعنف، لإخفاء المصالح ولتبرير العنف والاستغلال، هو من يحولها الى منظومات قيمية وايديولوجية تكرس الهيمنة الجنسية والتفوق الذكوري، و وسيلة لتأبيد أنظمة توزيع الأدوار والمكانات الجنسية غير المساواتية.فليس كل متدين بعنيف، وليس كل غير متدين بمساواتي. لكن التجربة المغربية علمتنا كيف يمكن للمنظومات القيمية الدينية عند تحنيطها عبر القراءة والتأويل الأصولي، يمكن ان تتحول الى مشروع سياسي يجعل من كتابة الأخلاق والقيم على جسد المرأة رأسمالا سياسيا لاحتلال السلطة ومراكز القرار العمومي.