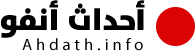AHDATH.INFO - حاورته سكينة بنزين
قبل جائحة كورونا، عاش المغرب العديد من الجوائح، ولعل هذا ما يجعل كلمة "الجايحة" في اللسان الدارج حاضرة في الخطاب اليومي، وإن كانت الأجيال المتأخرة لا تعي حمولتها ودلالاتها جيدا. في هذا الجزء الثاني من الحوار مع الباحث والكاتب خالد التوزاني، نقترب من مظاهر قاسية عاشها المغاربة حين اضطروا لأكل الجيف، وتعطيل الصلاة، إلى جانب خطوات احترازية تبرر سبب وجود "بيت خزين" في البيوت المغربية القديمة"، و وجود البئر بقلب الدار، وحضور الموضوع في قصائد تم التغني بها، إلى جانب تسليط الضوء طريقة استثمار المغاربة للفترات العزل المفروضة عليهم قديما، في تحصيل العلم والتعبد ...
الجوائح عموما تشكل مرحلة قاسية قد تفرز ممارسات استثنائية ربما يجدها البعض مرعبة أو مقززة، هل لك أن تقربنا من بعض الطرق التي اعتمدها المغاربة للتخفيف من شدة تداعيات؟
إنَّ ما تذكره بعض كتب التاريخ، من مآسي عاشها المغاربة بسبب انتشار الأوبئة والمجاعات، يصعب على القارئ أن يتخيّلها؛ كأن يأكل الناس الدواب التي نفقت، بل ويأكلوا موتاهم، أما تعطيل الصلاة فقد كان أمراً بديهياً، يقول صاحب كتاب الاستقصا متحدّثاً عن ما حدث سنة 1073هـ: "أصاب المغاربة مجاعة عظيمة أكل الناس فيها الجيف والدواب والآدمي، وخلت الدور وعطّلت المساجد"، ولم تكن الدولة أنذاك تملك القدرة على مراقبة جميع الأماكن والأسواق ومتابعة تطور الأحداث بالسرعة اللازمة خاصة مع قيام الثورات والفوضى والنزاعات، فاستغل بعض المسؤولين هذا الوضع، ليزيدوا إنهاك الناس بالضرائب والمكوس.
وقد وصف العلامة اليوسي ظلم الجباة وصفاً دقيقاً مؤثراً حين قال: "قد جردوا ذيول الظلم على الرعية، فأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ، ولم يتركوا للناس دينا ولا دنيا". كما وصف عبد الرحمن التامنارتي وغيره ممن عاصر تلك الأحداث، قائلا: نال المغرب من الفساد والفتن ما "طاش لها الوقور (...) ووضع النفيس وارتفع الخسيس، وفشا العار وخان الجار ولبس الزمان البؤس وجاء بالوجه العبوس (...) وطأطأ الحق نفسه وأخفى المحق نفسه (...) ووردت المهالك وسدّت المسالك وعمَّ الجوع".
هل بعد هذه الأزمات المخيفة والأهوال المجتمعة، أزمة أكبرُ منها وأعظمُ؟ لقد شهد المغرب في بعض الفترات التاريخية ما لم تشهده مناطق أخرى في العالم من الويلات والأزمات، واليوم إذ نستدعي الحديث عن بعض هذه التفاصيل التاريخية المؤلمة، ونحن في زمن جائحة كوفيد 19، التي لم تصب المغرب وحده، بل شلّت الحياة في جلّ ربوع العالم، وخلال فترة الحجر الصحي، التي انخرط فيها المغرب، كإجراء وقائي للحد من انتشار هذه الجائحة والسيطرة عليها ومحاصرتها، نروم بناء وعي المواطن المغربي واستنهاض مسؤوليته الفردية، للتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية، وذلك من أجل الخروج من هذه الأزمة العالمية بأقل الخسائر.
في الأزمنة الصعبة، كانت بعض الفئات من المغاربة، تعزل نفسها عن الخروج، وعن مخالطة الناس، فتدّخر حاجاتها من الغذاء، وتلوذ بالصيام، وتقليل الطعام، والكفّ عن الكلام، خاصة وأنها لا تتحرك كثيراً، فلا تحتاج للغذاء الوفير، وخروجها لا يكون إلا للضرورة القصوى، إننا اليوم عندما نتأمل المعمار الهندسي لكثير من المنازل في المدن المغربية العتيقة، نجدها تشتمل على بيت للمؤونة (بيت الخزين) أو ركن خاص بالتخزين، حيث يضعون الزيت والقطاني والسّمن والعسل والقمح، كما نجد في المنازل بئراً لجلب الماء، وكل ذلك تحت المنزل في القبو أو السرداب، حتى إذا وقعت الحروب والفتن والمجاعات، واقتُحِم البيت لم يعثر على أصحابه، فقد كانت في تلك المنازل مخارج سرية، ونوافذ صغيرة بين البيوت، تطل على الجيران، مختفية وراء بعض اللوحات والزخارف، وتُستعمل للتضامن بين الأسر المغربية، بتقديم الطعام لمن احتاج إليه.. أو الاطمئنان على الأسر والعائلات وتبادل الأخبار، كما استعمل المغاربة في تلك الفترات العديد من وسائل التعقيم والتنظيف، والكثير من وسائل الاحتياط، ولذلك نجا الكثيرون، بسبب التزام العزلة والابتعاد عن التجمعات، والفرار إلى البيت في خلوة طويلة، ثم إذا انتهى الوباء ومرت الأزمة، خرج هؤلاء في أمن وسلام، وعادوا إلى ممارسة أنشطة الحياة اليومية من تجارة وفلاحة وسفر وتعليم وغيره، وقد منَّ الله عليهم بعُمرٍ جديد.
ما أشبه اليوم بالأمس، في ظل الحجر الصحي، الذي لو التزم به كل المغاربة، لما طال وقت الجائحة في المغرب، خاصة وأنَّ بلدنا اليوم، وظّف كل إمكاناته لتوفير الغذاء للجميع، وتعويض الفاقدين لمصدر دخلهم، وتقديم كل الدعم الصحي والأمني والنفسي والمادي أيضاً، وهذه الإمكانات لم تكن متاحة في الأزمنة السابقة، الشيء الذي ينبغي أن يزيد من قوة التلاحم بين المغاربة وملكهم، فجميع المبادرات كانت صادرت من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لحماية المغاربة، وهذا التزام تاريخي ووفاء بعهد البيعة، من أعلى سلطة في المغرب، ليكون قدوة لغيره من المسؤولين، فيبادروا للعمل التضامني وأداء الواجب الوطني، وبالمقابل، على عموم المغاربة أداء واجبهم في التزام الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، والتطوع في أعمال البر والخير، والانخراط في حملة التضامن بالإسراع إلى وضع تبرعاتهم في صندوق تدبير الجائحة، وغير ذلك من المبادرات الفردية التي من شأنها أن تُعجّل بالقضاء على الوباء ومنع انتشاره.
لك العديد من الكتابات التي جعلتك على اطلاع مباشر مع تاريخ المغرب، وربما كان لك مرور على مراحل صعبة شهدها المغرب، إلى أي حد تساهم الجوائح كفصل من فصول التاريخ القاسية، في تشكيل مرحلة مفصلية قادرة على تغيير وعي المواطن والنخب؟
في مؤلفاتي ودراساتي اطلعتُ على الكثير من التفاصيل المؤلمة التي شهدها المغرب، في بعض الحقب التاريخية الصعبة، وقد تتعجب الأجيال الحالية وخاصة الشباب المغربي أو الذين لم يطلعوا على تاريخ المغرب، كيف خرج بلدنا من تلك الفتن وتجاوز الظروف الصعبة، حتى استمرت الحياة ؟
إنَّ للمجتمع المغربي ذاكرة قوية، لا ينسى الأحداث الأليمة كما لا ينسى الأحداث السعيدة أيضاً، وتأريخ الذاكرة المغربية للوقائع يتم عبر اللغة والعادات والتقاليد وأساليب العيش وأنماط التفكير، فنجد مصطلحات في الدارجة المغربية تستعمل للدلالة على الهلاك والويل والضياع، مثل "الجايحة" التي هي "الجائحة" وتقال لمن ضاع وانحرف انحرافاً شديداً مُهلكاً له (ضربته الجايحة)، ونجد لفظ "بوكليب الأكحل" الذي هو "الطاعون الأسود"، كما نجد المئات من قصائد الشعر الفصيح والملحون في محتوى تفريج الكربات، والتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم للشفاعة والتخفيف من المصاب، وشفاء المرضى وكشف الغم ورفع البلاء وتحقيق الأمن، كما أضفى المغاربة على بعض الأماكن طابع القداسة أو الرعب، مثل باب الشريعة، في بعض المدن المغربية كفاس وتازة ومراكش، أطلق عليها المجتمع المغربي اسم باب المحروق، نظرا لمشاهد حرق الثوار والمتمردين على السلطان في بعض الفترات التاريخية، وباب الجياف، بمدينة فاس التي كانت تلقى فيها جثثت الموتى من وباء الطاعون وتترك لتجف تحت أشعة الشمس.
ولكن الأجيال الحالية وحتى بعض النخب لا تعرف أصول هذه الكلمات والأوصاف والعادات أيضاً، التي تدل على أن المغاربة قد عرفوا الأوبئة والكوارث الطبيعية والمجاعات، وكافحوا من أجل البقاء، وطوّروا وسائل تدبير الأزمات، واكتسبوا بذلك خبرة مهمة، ترجموها إلى سلوك علمي ونمط في العيش، فقد كانت بيوتهم تتضمن مرافق لتخزين الغذاء، والمطبخ المغربي يضم وصفات تقي البرد وتدفع الجوع لساعات طويلة، ووصفات للعلاج أيضاً، وتميّز اللباس المغربي بخصوصيات الحماية مثل الجلباب والسلهام واللثام، إلى جانب ثقافة التضامن والتآزر، وقيم التضحية والإيثار، والقدرة على الخلوة والعزلة لشهور عديدة، حتى يرفع الله البلاء، وتمر المِحنة، وفي طياتها نِعمة وبركة، فكم من حافظ للقرآن كانت العزلة سبباً في حفظه، وكم من دارس لبعض العلوم، كانت الخلوة مناسبة لنبوغه وتعمّقه في القراءة والتأمل والفهم، فضلا عن بعض أرباب الصنائع والفنون والحرف، الذين أبدعوا في أوقات الحجر الصحي تحفاً فنية، وأعمالاً ظلت خالدة، كل ذلك خدم المغرب اليوم في مواجهة وباء كورونا فيروس المستجد، والذي يمثّل طاعون الأمس، ولكن بوعي اليوم وإمكانات العصر، لتصبح تجربة المغرب رائدة في مكافحة الأوبئة وجديرة بالتقاسم مع شعوب إفريقيا والعالم، فهذا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بعدما أطلق المبادرات التضامنية الرائدة لحماية صحة المغاربة وأمنهم، وأعطى أوامره السامية لكل مكونات الدولة المغربية بالسّهر على سلامة كل المغاربة داخل وطنهم وخارجه، تطلّع جلالته ليفيض من عطائه الإنساني على باقي شعوب العالم، وخاصة إفريقيا التي تربطه بها أواصر عقدية وروحية متينة، وروابط إنسانية عميقة.
ثم إن ما يشهده المغرب اليوم في هذه الفترة، من إجراءات تستهدف مواجهة جائحة كورونا، يشكل مرحلة مفصلية وفرصة ذهبية لتغيير وعي المواطن والارتقاء بالحسّ الوطني وروح المسؤولية والأمانة والالتزام، حيث أثمرت المرحلة ردود فعل إيجابية داخل المجتمع المغربي، وتتجلى في حجم التضامن الذي شهده المغرب، والتزام أغلب المغاربة بتعليمات الجهات الوصية، وأيضا شاهدنا رغم المخاطر الصحية خروج عدد من الشباب المتطوعين لتنظيم توافد المواطنين على الشبابيك الإلكترونية للبنوك والبريد لسحب المساعدات المالية التي قدّمتها الدولة المغربية للمتضررين من فترة الحجر الصحي، من العمال والحرفيين وأصحاب المهن والوظائف التي توقفت بسبب الاجراءات الاحترازية، كما شاهدنا العديد من أثرياء المغرب، يضعون فنادقهم ومصحاتهم رهن إشارة الدولة لتسخيرها في إيواء المصابين بالوباء، وشاهدنا المخترعين من الشباب المغربي والكفاءات العلمية الوطنية تبادر بتقديم حلول تقنية وبراءات اختراع جديدة، فاستطاع المغرب تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، والمعدات الطبية، ومواد التعقيم، والكمامات الواقية، والأدوية المعالجة، وغيرها، حتى إن المغرب تلقى طلبات من الخارج لتصدير بعض هذه المنتجات المحلية الصنع، كما شاهدنا وسائل الإعلام بكل أنواعها تتجند لتقديم برامج التوعية والتحسيس والانخراط في رفع مستوى الوعي الوطني، وشاهدنا تحوّل القنوات الفضائية والإذاعية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى أقسام دراسية تقدم الدروس عن بعد للتلاميذ والطلاب، بفضل جهود الأساتذة والعلماء الذين انخرطوا في عملية التعليم عن بعد، بكل جدية وإخلاص ومهنية عالية.
فحقّق المغرب في أسبوعين ما لم يحقّقه في عشر سنوات، لتتحوّل المحنة إلى منحة .. والحق يقال، إنَّ هذه البشائر، تمثل في الواقع شخصية المغاربة في أبعادها الروحية والتربوية والإنسانية التي أعادت للواجهة معنى الاستثناء المغربي، في الوقت الذي نشهد فيه أنانية بعض الدول وصراعاتها السياسية والحزبية الضيقة وحروبها الاقتصادية دون اكتراث بمصير المواطن.
ولأن الذاكرة المغربية حية وقوية، ولا تنسى الأحداث الكبرى، فقد أرّخ لهذه الجائحة عدد من المثقفين والأدباء فكتبوا المقالات والقصائد، كما خرج بعض الفنانين التشكيليين إلى الشارع ورسموا جداريات في منتهى الجمال تنخرط في تحسيس المواطنين وتوعيتهم ودفعهم إلى التزام الحجر الصحي وأخذ الاحتياطات اللازمة والتي تصدر عن الجهات الحكومية المعتمدة.
وبتأمل كل هذه المظاهر القوية في التصدي لجائحة كورونا، تتأكد يقظة المغاربة بكل مكوناتهم، وارتفاع مستوى الوعي، ومنسوب الوطنية الحقة، فالحالات الشاذة نادرة جداً ومعزولة، ويتم السيطرة عليها بسهولة، ولا شك أن المغاربة اليوم قد استوعبوا جيداً درس الجائحة، وبالتأكيد الآن يتم استثمار مكتسباتهم في مواجهة الأزمة، خاصة مع انخراط كل المكونات في حرب الجائحة، الشيء الذي ينبغي أن يُذكَرَ ويُشكَرَ، وينبغي أيضاً توظيف ما قد يُلاحظ من أخطاء في تدارك الأمر، قبل فوات الأوان، ولعل ذلك ما نشهده أيضاً، فهناك بلاغات تصدرها الدولة من حين لآخر تصحّح المسار وتقوّم السلوك المنحرف كلما ظهرت بعض الأخطاء والهفوات، وبهذا نستطيع التأكيد على أنَّ المغاربة فعلاً شعبٌ لا يُقهر.
أخيراً، هناك اليوم في المغرب، وهذا ما أصبحت ملامحه تتشكّل وتتأكّد يوماً بعد يوم، من يوميات مواجهة الجائحة، وما سيأتي بعدها، ملحمة جديدة بين الملك والشعب، وثورة إنسانية فريدة، بطلها العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي يقود التضامن الاجتماعي والإنساني ويعطي دروساً عمليةً في الحس الوطني العالي، والخوف الصادق على الوطن والمواطنين من كل مكروه.. وجعل بحكمته وحسن تدبيره، وتوكّله على الله، كل السلطات والقوى الحية تعملُ في خندق واحد دفاعاً عن كل مغربي أينما كان وحيثما وُجد، في القرى البعيدة أو المدن القريبة، في الشمال أو أقصى الجنوب وفي الغرب، أو أقصى الشّرق، بل امتدّت عنايته الكريمة وعطفه الأبوي وحنو قلبه الرؤوف الرحيم، إلى السجناء المغاربة لينالهم عفوه، ويخفّف عنهم الضيق، ويفرّج همّهم بإطلاق سراح الآلاف ممن أبدوا استعداداً للإصلاح والندم على ما فات، كما امتدت عناية الملك الرحيم لتشمل على كل مغاربة العالم، بل والإنسانية جمعاء، وهذه الثورة الروحية والأخلاقية والوطنية ليست من نسج الخيال أو الوهم بل تمثل واقعاً نعيش كل تفاصيله الحية ونشاهد أثره في المجتمع المغربي.
في الجزأ الثالث من الحوار سنتناول دور الزوايا في التوعية بالجوائح